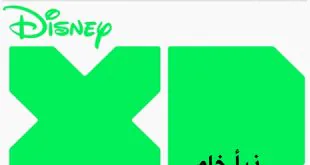كثيرا ما كنا نتسابق على فتح الباب إذا دق الجرس قبل الظهر؛ كان هذا هو الميعاد المتوقع لساعي البريد، أو بائع الجرائد، وبمجرد أن تظفر أختي بالخطاب الذي ننتظره بشغف، أفاوضها على قراءته، فليس عدلا أن تحصل وحدها على الحسنيين. كان الخطاب من أختي الكبرى منذ سفرها في أوائل الثمانينيات إلى جدة مع زوجها يقع على قلوبنا كالماء البارد في نهار رمضان، أو كفراش حرير لرجل هده التعب؛ كنا نتحلق كي نقرأ كلمات رسائلها حرفا حرفا، ونستشعر مشاعرها في كل سطر، نقرأ ونحن نتمثل وجهها، كأنها تكلمنا بصوتها العذب.
لا أعتقد أن الكلمات كانت تختلف من رسالة لأخرى، ومع ذلك كنا نجتمع لنستمعها معا يحركنا الشوق، والحنين، ويعتصرنا البعاد والافتقاد. وأما التواصل الصوتي فله حكاية أخرى؛ فلابد من ترتيب مسبق، وميعاد متفق عليه نذهب فيه لبيت خالي أو غيره من أقاربنا في المنصورة، فلم تكن التليفونات قد غزت قريتنا بعد. والحقيقة أنه لم تكن هناك مواضيع ذات أهمية كبرى، ولم تكن هناك ترتيبات لمشاريع، أو مناقشات لمواضيع، فقط نذهب لنتبادل سماع الأصوات فينطفئ جمر الشوق، وتتقلص مسافات البعد.
وأما أجمل الهدايا التي يمكن أن تصل إلينا بغتة من السعودية أن ينفتح الباب فنجد أحد معارفنا قادما من هناك، وهو يحمل بين يديه شريط كاسيت سجلته لنا أختي بصوتها، وما كان يثير شجوننا أكثر أن تظهر فيه أصوات أطفالها الذين تعلقنا بهم. نستمع كلماتها ونحن نتحرق شوقا وحبا؛ نحس بشوقها، وحبها الشديد من نبرة صوتها. إلا إننا لم نعش تجربة انتظار شرائط الكاسيت من والدي فقد كانت إعارته لاحقا إلى اليمن، وكان المدرسون يسافرون معا في بداية العام الدراسي، ويعودون في آخره في توقيت متزامن، بخلاف السعودية التي يسافر الأقارب أو الجيران منها وإليها على مدار العام. كما إن سفريات والدي جاءت متأخرة في أواخر الثمانينيات، وكانت طفرة الاتصالات قد بدأت خطواتها الأولى، وأصبحنا نتسابق جريا إلى التليفون الموضوع على قاعدته بجوار الثلاجة، وخصوصا إذا أعطى نغمة الترنك، وغالبا ما كان يأتينا صوت أبي من الجانب الآخر.
وأحسست مؤخرا أن صعوبة الاتصال والتواصل كانت صنو الإحساس بالغربة، ومرارتها، وأن ثورة الانترنت، والاتصالات قد جمدت الكثير من المشاعر، وكأن الورود البلاستيكية قد صارت بديلا موضوعيا للورد البلدي في الألفية الجديدة. لم يكن خيالي يسمح بتصور كامل عن تلك البلاد التي يسافرون إليها. ولكني كنت مشغولا من قديم بتفاصيل الأشياء، فأسأل نفسي ما شكل شوارع العراق؟ وكيف تبدو بيوت الأردن؟ وما أشهر أطعمة ليبيا؟ لا يقين عندي في أي تصور إلا من شيء واحد، وهو أن تجربة السفر أشبه برحلة تعذيب، وتغريب، وانخلاع من الجذور. كنت أظن أن دموع المغتربين إذا تجمعت فيمكن أن تسير بحرا، وأن أحزانهم تكبر يوما بعد يوم حتى تتوحش وتكاد تنقض عليهم فتهلكهم، لولا أنهم يدركون أنفسهم فيفلتون في اللحظة الحاسمة، ليعودوا إلى أوطانهم في إجازة تحفظ عليهم بقاءهم، وتشحذ طاقاتهم لسنة جديدة من الاغتراب.
وفي سن أصغر كنت قد سمعت أكثر من مرة بعض شرائط الكاسيت بأصوات معارف لنا، لم يكن كلام الشاب من أقاربنا، أو الرجل من جيراننا يتخطى فكرة إرسال السلام لست الحبايب، أو الزوجة، وطلب الدعاء للقدرة على تحمل مرارة الغربة، ولا يفتقد الكلام للشكوى من الغربة وسنينها، وبعد أن يتكرر الكلام أكثر من مرة، ولا يجد ما يملأ به فراغ الشريط، يرسل أغنية يهديها إلى أمه، وغالبا ما تتكلم عن اللوعة والاغتراب والحنين، مما يستدر الدموع، ويعمق الآلام، ويوقد لوعة القلوب. وقد رأيت حينها أن فكرة إرسال شريط كاسيت من بلاد الغربة أكثر قسوة من الاغتراب نفسه في بعض الأحيان.
لم يقتصر دور الكاسيت على أشرطة الأقارب، والمسافرين، ولكنه كان بداية للسماع الاختياري، انتشرت ألبومات الكاسيت في المنازل، وسيارات الأجرة، والمحلات. ولا أظن أن أحدا ممن يعي منتصف الثمانينيات نسي صيف “لولاكي”، أتمثل الآن سوق رأس البر ليلا، وجميع المحلات تدير أغنية علي حميدة الشهيرة حينها، لا صوت يعلو فوق صوت “لولاكي”، ولا يكاد شاب أو فتاة من المارة يمشي دون أن يتمايل وهو يردد كلمات الأغنية، ممسكا بيده أيس كريم، أو غزل البنات، أو كيسا من الفيشار دون خجل باعتبار أن ليالي المصيف يمكن التجاوز فيها عن الخروج عن المألوف والطقوس العادية. ولن ينسى هذا الجيل أيضا أغنية “كامننا”، وبقية أغنيات فيلم “إسماعيلية رايح جاي” الذي دشن فيه محمد فؤاد، وهنيدي مرحلة جديدة من السينما التي تحتفي بالشباب وبالجيل الجديد. لكن الأكثر عشقا وهياما من مراهقي هذا الجيل قد اتجهوا إلى فكرة الكوكتيل، عندما انتشرت محلات الكاسيت وقتها في سباق مذهل، فكان الشاب يختار أغاني الألبوم الذي سيهديه لفتاته، ويصنع الشريط على عينه، وبالمثل كانت تختار الفتاة أغانيها، وكلماتها بعناية فائقة، وغالبا كانت قد انقرضت فكرة الخطابات بين أطراف قصص الحب من مراهقي هذا الجيل، فوسائل التواصل كانت قد بدأت حثيثا في إرهاصاتها الأولى.
وكما كان لجهاز التسجيل هذا الدور الجبار حينها في فكرة الاتصال، والاختيار، فقد امتلأت الشوارع والميكروباصات أيضا بأشرطة عذاب القبر، وعلامات يوم القيامة، وتلاوات شيوخ الخليج الباكية، وأذكر أن أبي اشترى لي جهاز كاسيت صغير في حجم كف اليد في بداية مرحلتي الجامعية من أجل تسجيل المحاضرات، ولكني لا أذكر أني استخدمته مرة واحدة. ولأن الكاسيت في العادة هو نصف الجهاز، والراديو نصفه الآخر فقد ساهم -ولو من باب خلفي بشكل ما- في استعادة دور الراديو بعد تراجعه المذهل لصالح غول شاشات التليفزيون. أتخيل الآن التسجيل حكما فصلا بين الراديو ذلك الأخ الأكبر الذي أصبح “دَقَّة قديمة”، وبين الشاب الفتي الذي يمثله التليفزيون العائد للتو من رحلة اغتراب وخبرات، عاد متمردا على تقاليد الماضي البالية، أتخيل أن الكاسيت قد قام بدور الوسيط، أو العاقل، ليعالج الجراح، ويسد الفجوة، وقد استطاع الكاسيت بالفعل أن يصنع حالة من التوازن والمواءمة بين الراديو والتلفاز، حتى إن جهاز التسجيل ملأ عليَّ أوقاتي في نهاية حياتي الجامعية، وقد مثل نصفه الآخر لي وهو الراديو صديقا مخلصا لي، طالما قضينا الليل معا نطوف من محطة لأخرى.
انقطع حبل ذكرياتي على اتصال صوتي من ابني نزار يخبرني بصوت يملؤه الفرح والسعادة أنه استطاع أخيرا أن يتفوق على صديقه الباكستاني عبر الأنترنت في لعبة مدينة التنانين، أو ربما أرض الأشباح، لست متيقنا عن أي المدينتين حدثني، ولكنها على أية حال لعبة يوحي اسمها بالرعب والخوف والترقب، ولما طالت مكالمتنا، أراد صديقي أن يستغل الوقت أثناء انشغالي ليتصل بابنه من خلال الفيديو شات عبر الحدود ليشرح له مسألة الرياضيات التي حيرتهما ليلة أمس.
قال صاحبي: لكن قرارا خطيرا قد اتخذته السلطات بالأمس فقط. كان ذلك هو إغلاق جميع برامج المكالمات الصوتية، والفيديو شات من غير التليفون. فخمنت أن هذا ربما يكون بغرض محاربة الإرهاب، وربما لسهولة متابعة الخارجين على القانون. في حين أخبرنا الأكثر خبرة في التكنولوجيا عن برنامج يمكن استخدامه لتفادي هذا التضييق، وكأن رقابة لم تحدث، وكأن شيئا لم يكن.
————-
د. محمدخيري الامام
 نبأ خام
نبأ خام